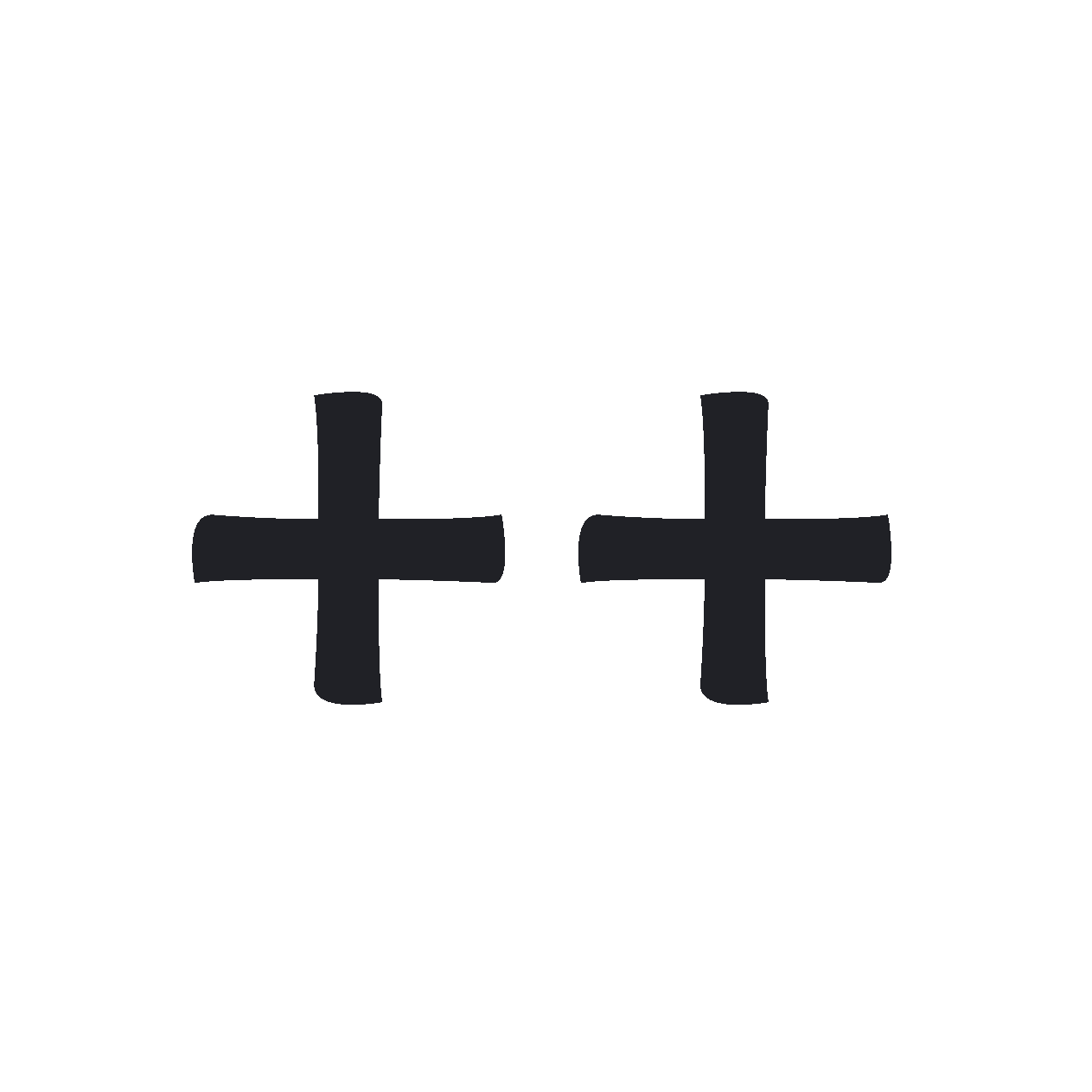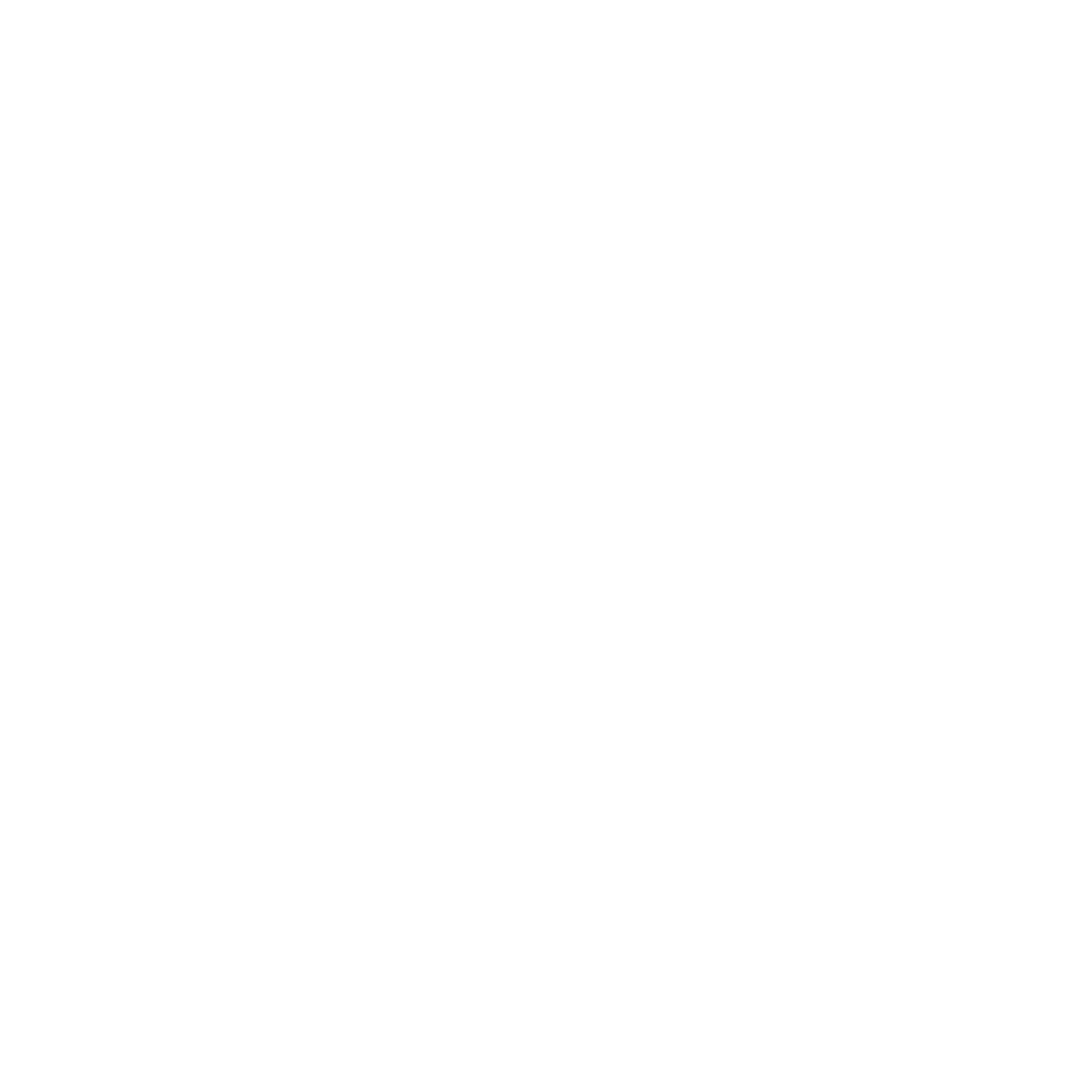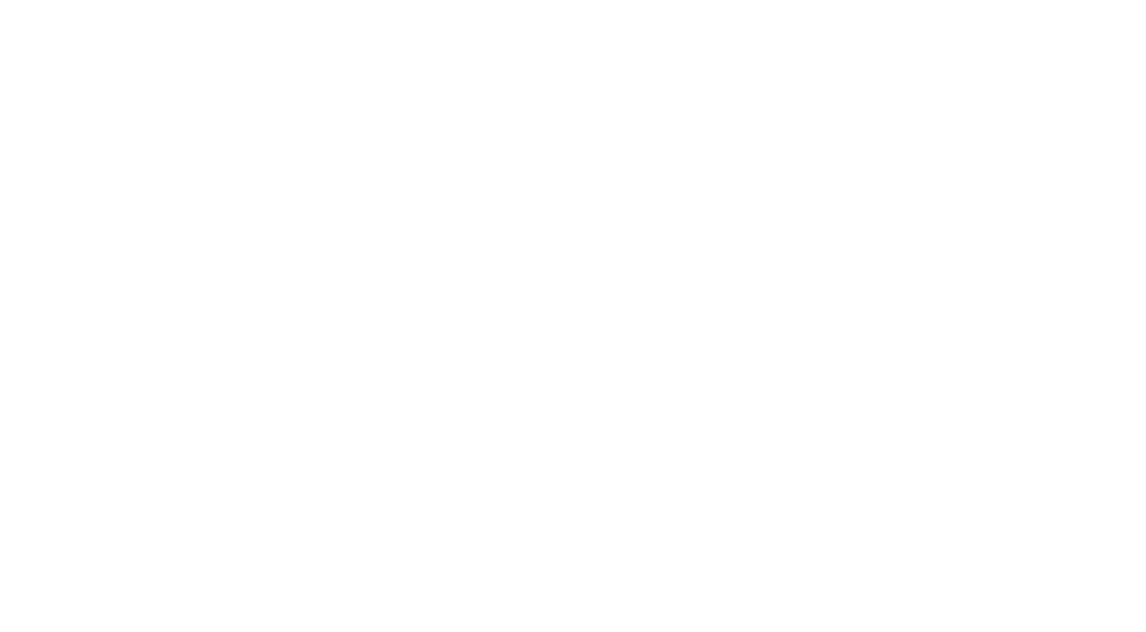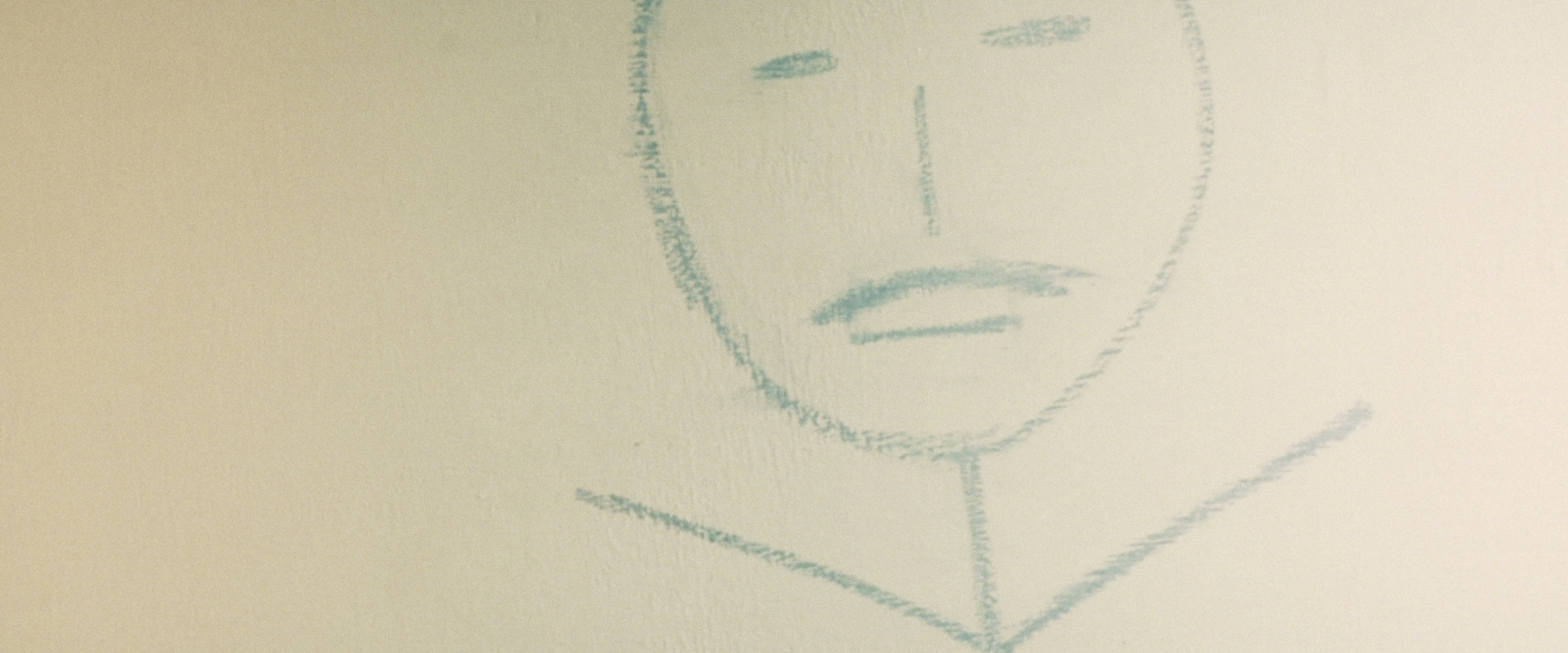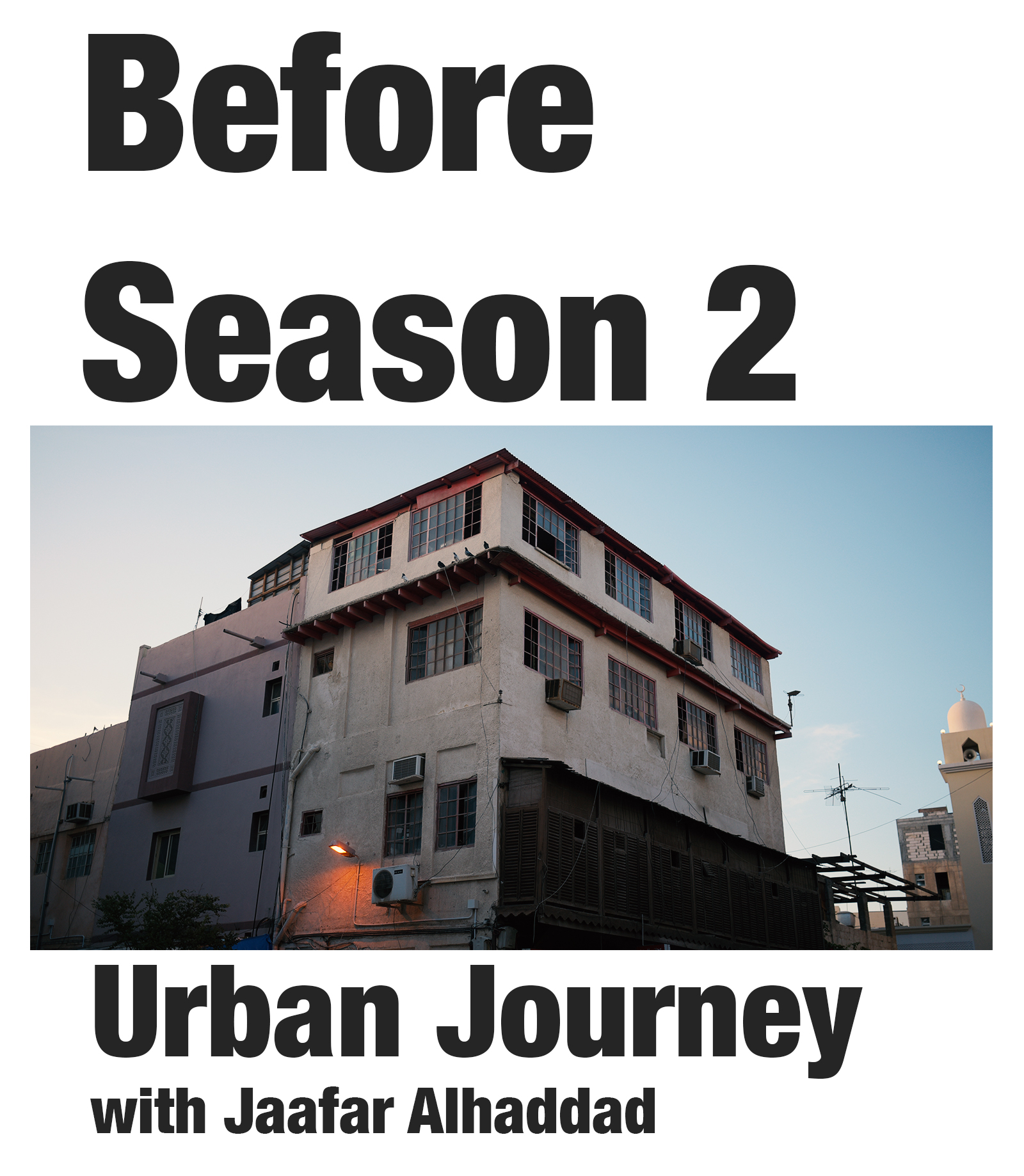منذ نشأتي هذا الصباح لم أر سوى وجهه، أبيض اللون، أزرق العينين، شعره داكن، و له نظرته تأسر كل من له قلبٌ ينبض بالحياة، كان لا يتوقف أبدًا عن الكلام، فلا ينفك من حكاية حتى يسترسل بأخرى، كنت أشعر أنني أغرق في مستنقع موحل من الهراء، و لم يراودني -طيلة الساعات الأربع الماضية معه- سوى سؤال واحد، متى سينتهي هذا المعتوه من هرائه المضجر؛ لأنني كنت لا أجد لقوله من فائدة تذكر و لا من علمٍ ينتفع به، و لا من خبر يدعو للاهتمام، و لكن فجأة اقترب لي خطوة، حتى أصبحت بعض البثور في وجهه واضحة المعالم، كنت أشعربشيءٍ مثيرٍ قادم، و أنصت له لأول مرة منذ نشأتي، نعم … قد أحصل على فائدة من هذا الينبوع الفتيّ.
“واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ســـ … ستة أم سبعة، آآآآآآه لقد نسيت”، بدأ صديقي حديثه هذا، لم أحسن العد كالعادة،إذاً لن العب مع أبناء حارتي لعبة الإختباء اليوم،
كنت واقفاً على عتبة باب منزلي الصغير الواقع في حيّنا المليء بالأزقة الضيقة وسط العاصمة،
كنت أجهل العد كما أنني لم أعد أذكر اسماء من حولي إلا القليل،
حالتي المرضية صعبة، ولكن رغم هذا الألم الخانقة كنت أذكر أشياء غريبة،
كنت أعلم أن جارتي النحيفة التي تقع على يميننا
ستأتي و تسألني كعادتها عن اسمها الذي لم استطع أن أفتتح بحرفٍ
واحدٍ منه قط رغم سؤالها المتكرر،
و كنت أذكر مدى بغضي وعدائي لجاري الأصلع القبيح الذي يقبع
في منزله المتهالك يسارنا كذلك،
كنت أوقن بأن مشاعري تجاه الناس كلها صادقة ولا تحتمل الخطأ،
فكل شيء من حياتي متراكم على صرحٍ شامخٍ من التجارب”.
“الساعة الثالثة بعد منتصف النهار، لازلت على عتبت بابي، خمسة عشر سنتيمتر هو ما يفصلني عن الأرض، هويت برجلي اليمنى عليها، و هممت بالمشي، فلم تمر جارتي بي هذه المرة، كانت وجهتي مجهولة، ولكن طريقي معروف، فكنت دائم السير عبر الزقاق الرابع على يسار المنزل، حيث يوجد ذلك البيت المهجور، ذو النوافذ الضخمة المهشمة، و المصبوغ بلون الرماد، كان أشبه بدار للمآسي أو ملجأٍ للكوارث، ضخمٌ … و بهِ قبو عظيم أسفله، لكنني لا أستطيع إلا أن أراقبه عن بُعد، فالشائعات تسري أن مجموعاتٍ من عفاريت الجن شديدوا البأس يتخذونه مسكناً لهم، و إنني لا أذكر أن أحداً من قريتنا قد قَدِر على أن يخطوا نحوه بخطوه أو أن يمضي قدماً لدخوله و استكشافه، بل ويروى أن أبناء حارتي كانوا ينتصفون هذا الزقاق بلعب كرة القدم و بتسديدة خاطئة تخطت الكرة كل ما أمامها إلى أن أستقرت داخل ملجأ العفاريت هذا، و ما هي لحظات إلا بمقذوفة تستقر بقربهم، ما هذا !!!! إن الكرة عادة لنا مفلوقة من متصفها، و من ذلك اليوم لم يعد هذا الزقاق مكان لعب لهؤلاء السذج”.
“رغم ما يرى الناس و يسمعون من أعماقه فإن عمي مازال مستقراً في بيته المجاور له، كان شخصاً بديناً أبيض اللون وذو أعين قزحيتها خضراء، طيباً بشوشاً، يقدم لي العطايا كلما رآني، ولا أخفي عليك سراً، فما كان مساري على هذا الزقاق إلا لأكتسب قليلاً من غنائمه المجهزة لعطاء كل من يمر به، و كان هذا ما حدث ، فحينما أقتربت من بيته ناداني بلطف و قدم لي خمسة دنانير دفعة واحدة و قطعة من الحلوى، لشخصٍ في الخامسة عشرَ مثلي هذا كثير، -ورغم مرضي- فكنت أعلم علم اليقين اسمه ولن أنساه أبد الدهر، صلاح هو اسمه وكريمٌ هي صفته ولقبه القريب لقلبي هو صلاح الكريم، و لعل لا أحد يناديه بذلك غيري، ولكن هذه الصفة لم تعيق أهل الحارة عن هجرانه، فهو وحيدٌ منذ أن فارقت زوجته المحبوبة هذه الدنيا، فلم تكن سمعته تحتل محلاً حسناً من قلوب الناس، و لم يكن يفأد إليه إلا القليل من وفى بعهد صداقته معه، و لعل سمعته السيئة كانت بسبب إشاعة أبتدعها سفيهٌ من سفهاء هذه الحارة، و لعل سببها كان فقط مجاورته لهذا البيت المهجور، فإنني أذكر جارتنا النحيفة تحدث أمي بأمورٍ شنيعة عنه رغم أن أمي لا تقول لي سوى نقيض قول جارتنا، و إني لأحسب كلام أمي صائبا.”
“تجاوزت منزله، وببعضِ خطوات دخلت الزقاق الآخر، كنت أحب هذا الممر الضيق، فهو هادئ تملئه أشعة الشمس طيلة اليوم إضافة إلى الروائح العطرة التي تلوج فيه، و بعكس هذا كله، كان الجو مظلمٌ خانق هذه المرة و لم أشم سوى رائحة الدم تتسرب من باب منزلٍ جديدٍ، كتب على يمينه (( منزل الحاج عبدالله محمد البنّاي }أبو أحمد {))، كنت أذكر أن كل ما بحيّنا يعرف فضله و إحسانه، و الناس لا يتوقفون عن الوفود لداره، و لكن عجبت لرائحة الدم هذه، -في الواقع- كان الفضول يقتلني و يحرقني بناره، كان لابد من فتح ذلك الباب، يا لجرأتي، فتحت الباب، فشخص بصري، و حار فكري، و تهت لا أعلم ماذا أفعل، كنت كقريحةٍ تاهت عنها الكلمات، و كجدولٍ أوقف الجفاف عنه ماءه فجأة، كان مشهدًا شنيعًا للغاية، فقد رأيت أحمدًا مسجى على الأرض، يملئ جسمه العديد من الكدمات، تقطر بالدم، و آثار الجَلد منتشرة في بدنه، ثم لاحظت ذلك الحزام الجلدي الغليظ، كان يمسكه والده في يده اليمنى ذات الست أصابع، تلك اليد المعطاء، و لن أنسى نظرات والده له و هي ترسل رسائل الكراهية و الإنتقام لذلك الوجه الحزين البريئ …”
(أحمد ، أحمد) توقف الحديث، ( أحمد عبدالله ) توقف إنصاتي، ( أحمد عبدالله محمد البنّاي، البنّاي، البنّاي ) كان نداءًا بصوتٍ رخم يأتي من خلف باب الغرفة الصغيرة التي كنا بها أنا و صديقي ، ( هيا لقد حان موعد جرعتك من عقار السيروكويل)، تقدم خطوة نحوي، حتى أصبحت أرى مسامات وجهه، و قال لي: “ها قد علمت أني أتعالج من الهلوسة بعقار السيروكويل، فلا تخبر أحداً … أتفقنا ؟!”
لم أكن أستيطع الرد عليه بكلمة حتى،فمن يحتمل هذا العنف الذي يكون من أقرب الناس لك و أفضلهم زلفةً لديك، و بينما أنا أعيد ترتيب ما حصل أمامي، رحل أحمد، و بعد لحظة، تقدم من خلال الباب شخصٌ أسمرٌ باسق الطول، يلبس معطف أبيض، و بين يديه سماعة طبية، إنه ثاني فرد أراه في حياتي، و لكنه كان عكس ذلك الفتى، كانت نظراته لي حادقة، و كان صامتًا لدرجةٍ مزرية، بقي هكذا للحظات، أشتقت بها هراء ذلك الفتى، ثم إستدار و خرج.
لم أكن قد أستوعبت ما جرى بعد، حتى دخل عليي شخصٌ ثالث، لكن هذه المرة كانت إمرأة، تكتسي بلباسٍ أبيضٍ ناصع، و بيدها إسفنجه تشخل ماءًا كثيرا، و بدأت تزيل رجلي عن ذلك الجدار لأزرق الرفيع، كان يسيل مني ماءٌ أسود، كانت تتقدم من أسفل جسدي للأعلى، كنت أشعر بأن أطرافي تتلاشى، كانت دقيقة جداً، لا تترك أثراً بعدها أبداً.
شعرت لوهلة، أنني يجب أن لا أسكت عن هذه الجريمة، إتخذت القرار، سأحكي لهذه المرأة ما حدث لذلك الفتى، فأنا الآن أعرف قصته، و لكن كان الأوان قد فات، فقد مسحت فمي المبتسم، و بحركة غريبة، مسحت حدود رأسي، تاركةً عيناي للنهاية، لم أكن أعلم ما حِكمت هذا الفعل، و لكني شعرت كيف تكون الضحية المستضعفة، أن أشعر و أرى و لكنني لا أستطيع التحدث عن ما يحدث لي، ثمغابتالرأيةتدريجياً.
“الآن أصبح الجدار نظيفاً” ، قالت الممرضة.